
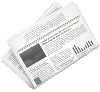
الجنوب، لم يكن فقط ساحة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، بل حقلاً لإعادة تشكيل رمزية النضال ذاته.
من هنا نفهم لماذا شكلت القضية الجنوبية مركز جذب لرسامي الكاريكاتور في البحرين (المحرقي)، والكويت (العوضي وآرتي)، وسوريا (الشماع، قاروط، بصمه جي)، بل حتى في تشيلي وفنزويلا والبرازيل، حيث الذاكرة القتالية للماركسيين اللاتينيين تقاطعت مع سردية الجنوب كموقع لآخر أشكال النقاء الثوري.
انقسم رسامو الكاريكاتور
اللبنانيون على إيقاع
الاصطفافات السياسية
هكذا عندما نرصد كاريكاتوراً من السبعينيات يصوّر جندياً إسرائيلياً بوجه وحش، أو طفلاً فلسطينياً يحمل حجراً في وجه دبابة، لا نكون أمام «رأي فني»، بل أمام تجلٍ لاختزال سيميائي يفتح الباب لما يسمّيه بعضهم بـ«اقتصاد الصورة»، أي التحكّم بمفاعيلها الإدراكية والانفعالية.
الجنوب لم يكن يوماً «موضوعاً» بل «جهاز إسقاط». وكل كاريكاتور عنه هو في حقيقته اعتراف غير مباشر من الذات العربية والعالمثالثية عن مكبوتاتها. في كل عين دامعة مرسومة، كان هناك طفل في أميركا اللاتينية يرى صورته. في كل بندقية مرتعشة مرسومة، كان هناك سوري، بحريني، كويتي، يحاول إعادة اختراع رمزية الفعل.
لقد قدّم الجنوب للبشرية نموذجاً لا للمقاومة فقط، بل لفعل القول المقاوم. قال بول كلي: «الفن لا يُظهر ما يُرى، بل يجعل ما لا يُرى مرئياً». والكاريكاتور الجنوبي، في قمّته، فعل ذلك. جعل من الغياب حضوراً، ومن القهر جمالاً تعبيرياً، ومن الخط الثخين لغةً لا يقرؤها إلا من خَبِر الخوف والرصاصة والحنين في آنٍ معاً.
منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، لم يكن التفاعل مع القضية الفلسطينية وجنوب لبنان مجرد موقف سياسي، بل تحوّل إلى بُنية وجدانية عميقة تمظهرت في الفنون التعبيرية، وعلى رأسها فن الكاريكاتور.
على امتداد العقود، برزت الريشة الإيرانية كرافد بصري مُخلص، وشريك تعبيري للقضية الجنوبية، تحمل وجعها، وتعكس نضالها، وتمنحها حضوراً في المخيّلة الجماعية الإيرانية يتجاوز الجغرافيا ويتغلغل في عمق الهوية الثورية الجديدة.
تحوّل الجنوب اللبناني، في رسوم فناني الكاريكاتور الإيرانيين، إلى ما يشبه الرمز الطهوري — حقل اختبار للوفاء، ومعياراً رمزياً لصحة الموقف. لم يكن لبنان بالنسبة إليهم بلداً صغيراً على الخريطة، بل بؤرة كثيفة للمواجهة مع المستكبر، ومرآة تتكثف فيها صور الثورة، والعدالة، والكرامة.
في ملصقات ومعارض ومجلات، بدا الجنوب كأنّ له وهجه الخاص، كأنه لا يُرى فقط بل يُعاش، كأنه يمتلك سحراً حسّياً قادراً على النفاذ إلى وجدان شعوب لم تعرف حدوده الجغرافية، لكنها تعرف معناه الدلالي.
لم يكن الكاريكاتور المصري، في تيّاره الرسمي، مناصراً لما كان يحدث في جنوب لبنان من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية متكررة. بل على العكس، فقد بدا هذا الفن، في حقبة الرئيس أنور السادات وما بعدها، خاضعاً لانعكاسات التحولات السياسية الكبرى التي عصفت بالموقف المصري، خصوصاً مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 وما تبعها من انكفاء عربي رسمي عن الصراع، وانزياح في بوصلات الالتزام القومي.
هكذا، أصبح الكاريكاتور جزءاً من سياسة الصمت أو التحييد، إذ لم يعد الجنوب يُرى كجبهة مشتعلة من أجل الكرامة، بل كحقل متروك لمصيره، كأنّ على الفن أن ينسحب على خطى السياسة.
لكن هذا الاصطفاف لم يكن شاملاً. فقد شذّ عنه بعض الفنانين المحمّلين بوعي يساري راسخ، وبإيمان عميق بأنّ الفن لا يمكن أن يكون محايداً في وجه الظلم. من بين هؤلاء، برزت أسماء مثل بهجت عثمان، الذي واصل رسوماته الناقدة حتى في وجه المدّ الرسمي، مستخدماً السخرية الحادة كسلاح ضد الانبطاح، ومحيي الدين اللباد، الذي جمع بين رهافة التشكيل وصرامة الموقف السياسي، فرسم الجنوب كما يرسم ذاكرةً عربيةً جريحة، حافلة بالتآمر والنسيان. وكذلك هناك نبيل السلمي، الذي تعامل مع الكاريكاتور كأداة كاشفة للمسكوت عنه، وجعل من الجنوب فضاءً لا للاحتفاء، بل للمساءلة القاسية: لماذا تُرك وحده؟ ولماذا صمتت القاهرة؟
• أبجديّة ناجي العلي
في رسوم ناجي العلي، لا يظهر الجنوب كديكور للبطولة، بل كمعادل حسّي ووجودي لفلسطين، حيث تتبادل الأرضان الجرح والملامح. بريشته الحادة التي تشبه نصلاً لغوياً، رسم الجنوب كجزء من جسد فلسطين الممتد، كركبةٍ لقدم الفدائي، كصدرٍ يتنفس من الجهة الأخرى من النكبة.
في أحد رسومه، تجسّد الجنوب في هيئة امرأة تحمل جرّة ماء، تسقي منها فدائياً يعتمر الكوفية: مشهدٌ بسيط ومتفجّر في آن، حيث تتماهى الأنثى بالأرض، والماء بالانتماء، والخلفية السوداء بالصمت الذي يبتلع الناظر لا ليريه، بل ليُفرغه من سلبيّته. هكذا يصبح الرسم ليس حكاية بل طقس بصري للانغماس.
وفي رسم آخر، يربط ناجي نير الفلاحة، ذاك الرمز العتيق للكفاح اليومي، بذيل صاروخٍ معادٍ. لكنه لا يفعل ذلك بوصفه موقفاً أيديولوجياً، بل كتحويل راديكالي للرمز: الصاروخ الذي صُمّم ليفني، يُستثمر ليزرع. هكذا تتفكّك أدوات العدو وتُعاد برمجتها ضمن خطاب المقاومة.
إنها ليست مفارقة تقنية، بل إعادة صياغة للعالم: الفلاحة تتحوّل إلى أداة اختراق، الأرض تصبح آلة تفكيك للعدوان، واليد التي كانت تدافع تصبح يداً تُخصب.
في المشهد الكاريكاتوري اللبناني، لم تكن الريشة محايدة يوماً. لقد انقسم رسامو الكاريكاتور على إيقاع الاصطفافات السياسية، بين مَن جعل من الجنوب مرآةً للمقاومة، ومن جعله حقلاً رمادياً للشك، أو حتى ممرّاً لتصفية حسابات أيديولوجية.
في الطرف الأول، تقف أسماء مثل ملحم عماد، نبيل قدوح، محمود كحيل، حبيب حداد، ومحمد نور الدين، ممّن حمّلوا ريشتهم أثقال الجنوب، لكن كلٌ منهم بلغة مختلفة، بإيقاع تعبيري متباين، وبخطاب جمالي يستبطن قناعاته وسياقاته.
بعد انتصار عام 2000،
وصلت التعبيرية الكاريكاتورية
إلى ذروتها الرمزية
نبيل قدوح، مثلاً، لم يكتفِ برسومات الصحيفة، بل حوّل الجنوب إلى أيقونة صامتة في سلسلة ملصقات ومؤلفات توثيقية، مزج فيها التعبير الغرافيكي بالصرخة الرمزية، كأنّ الريشة تُقرأ خرائط الدم وتحوّلها إلى أناشيد ضوئية. أما محمود كحيل، بهدوئه البصري وسخريته الماكرة، فقد قدّم الجنوب كقصيدة حزينة تُروى بأبجدية الوجع، من دون صراخ، بل عبر استنطاق المساحات البيضاء وتهشيم الرموز السلطوية بالصمت لا بالهتاف.
وعلى الضفة الأخرى، كان الكاريكاتور اليميني يتحرك في فضاء مزدوج: اعتراف بألم الجنوبيين، لكن نفور من الرمز المقاوم. في كثير من أعماله، بدا بيار صادق متعاطفاً مع المدنيين، مع الضحية كفرد، لكن من دون الغوص في الشرعية الرمزية للفعل المقاوم.
جان مشعلاني اتخذ موقفاً وسطياً، كمن يرسم وهو ينظر خلفه، حذراً من أن تلتصق به تهمة الانحياز. أما ستافرو جبرا، فقد دخل مرحلةً صريحة من التواطؤ الرمزي، إذ استقبل الاجتياح الإسرائيلي في رسوماته كنوع من «التحرير» البصري، مصوراً أرييل شارون كمخلّص مزعوم، ينظف لبنان من «البقع» الفلسطينية والسورية، في خطاب بصري يتماهى بشكل مخيف مع ما تفوّه به الشاعر سعيد عقل في تسجيل مسرّب لاحقاً.
بعد انتصار عام 2000، لحظة اندحار «الجيش» الإسرائيلي من جنوب لبنان، وصلت التعبيرية الكاريكاتورية إلى ذروتها الرمزية.
بدا الكاريكاتور، في تلك اللحظة، كمن يختزل التاريخ برمشة خطّ، يرسم الانسحاب كولادة جديدة، لا لجنوب لبنان فقط، بل لفكرة المقاومة نفسها. كانت الصورة تحمل نشوة الانتصار، لكن تحتها، كان الجرح القديم يتبدّل: فالمعركة التي كانت يوماً أممية الهوى، جامعةً للأقلام والريش والمنابر، بدأت تتعرض لتصدعات سردية.
مع أفول دور «منظمة التحرير الفلسطينية» على إثر مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو (1993)، ودخول المنطقة رسمياً في «العصر الأميركي»، حيث أعادت واشنطن تشكيل الأولويات والخرائط والخطابات، بدأت المسافة تتسع بين عدد من فناني الكاريكاتور وبين قلب المعركة الرمزية: الجنوب، وفلسطين. لم تعد القضايا التحرّرية مركز ثقل التعبير، بل بدأ الكاريكاتور العربي يتماهى مع منطق السوق، ومع ديبلوماسية الحياد الزائف، ومع سخرية مسطّحة لا تعادي السلطة، بل تعوم فوقها.
بدا كأن الرسامين، الذين دائماً ما شحنوا صورهم بدموع الأمهات وملامح الشهداء، قد أداروا ظهورهم فجأة. لم يعودوا يرسُمون الوجع، بل أخذوا يختزلونه في نكتة ساذجة.
هكذا انقلبت المعادلة: من الريشة بوصفها رفيق البندقية، إلى الريشة كأداة تحييد، ثم كرمز خضوع ضمني. كأن جزءاً من النخبة الثقافية والفنية دخل في ما يشبه الكمون السياسي، إما بسبب التعب، أو الخوف، أو إعادة تموضع ضمن خريطة «الواقعية الجديدة» التي فرضها رأس المال والإعلام المتواطئ.